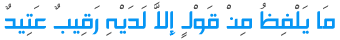[color:8f9a=منذأن عرفت قصيمي]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لفت نظري اليوم وأنا اتصفح عنوان هذه الروايه
حنين اللوزن الأزرق
فأحببت أن نقرأها سوياً 
حنين اللون الأزرق
الإهداء:
إلى اللذين عرفاني الله, محبة وطاعة وسلكاً:
والدي ووالدتي.
إلى روحيهما الطاهرتين.
أقدم ـ بخشوع ـ هذا العمل المتواضع.
وهيب
حنين اللون الأزرق _1_
ملأتني رغبة جامحة في التعرّف إليه. كنت قد تركته منذ أيام الدراسة الأولى. ولكن عندما ذاع خبره، جرفت برغبتي هذه، وصمَّمت على أن أشبع فضولي به. أذهب إلى حيث يقيم. وأشاهده من جديد.
المشاهدة عن قرب تجعل لي القرار في أن أكرر هذه الزيارة أم لا. أن ألازمه وأتبع (سلكه) أو أن أمتنع كلياً عنه...
لكن أراني، منذ الآن قد مِلتُ إلى الخيار الأول. وسأحمد، لي فضولي!
بالمناسبة، الفضول ليس عملاً زائداً لدى الإنسان، كما يشاع عنه بل هو ضروري وأساسي، في كثير من الأحيان، وهل تنسى البشرية ما قدمه هذا الفضول لـها، على مدى تاريخ حضارتها الطويل؟ فضول عباس بن فرناس في طيرانه. فضول نيوتن في حركة تفاحته، فضول (واط) في غليان ماء إبريقه....
لن أطيل. هاأنذا بفضل هذا الفضول، أجدني أقف وجهاً لوجه، مع الرجل الذي وددت مقابلته. أجل. إثر إلحاح حلم، تكوّن في ثنايا الليل، ألمَّ بي قبيل الفجر. ورحت أطارد طيفه مثل الهذيان، حتّى عدت من تلك الديار.
حين عدت وسألت، قيل لي إنه يسكن في رأس القمة. كظمت صبري وتعبي، وتابعت.
ـ الزمن: معطّل لم يحسب.
ـ الطريق: سرت في درب ترابي، من أسفل السفح. تشعب من عدّة دروب متجهة صوب القمة.
واصلت السير صعداً. وأنا أدوس جذا ذات أوراق الأشجار، التي تساقطت، بفعل وجع الخريف، وعرَّت عراجينها القشيبة. لم أبال بحزن الطبيعة من حولي، إذ أخذتني طيور السمن والمطواق والحسّون، تشنّف أذني، وهي تعزف أغنية الفصول الهاربة، وتملأ البطاح والسفوح زقزقة وسحراً.
بلى كان ذلك خلال لحظات شروق مسروقة من خلف تلال النور والعبير.
بانت لعيني، في الأفق المعلَّق صنعة الله العظيمة. كيف تقاطرت الهضاب والجبال بسلاسل متلاحقة، متلازة. كسحب عملاقة حطّت على الأرض وتجمدت.
لغفت المفاوز المفغورة. وتنقلت بين المصاطب المتجهة نحو الأعلى، كمن يتسلق ناطحات سحاب. حجارة هنا وصخور هناك. وعورة لا مثيل لـها!!
نلت الأمرين. لِمَ هذه العزلة كلها، في ذاك المكان العالي؟ من بنى الحصن في شمراخ الجبل؟ أو من بنى المعبد؟.
حقيقة، لا أدري، أهو حصن أم معبد؟ على كل حال لم يساورني أي خوف من وحشته. إيماني درع سليمان في داخلي، مطلسم ضد كل الغيلان والأشباح. غير أنني سأنحني في نفسي، لذاك الإنسان القديم كما ينحني جسمي، الآن، بهذا الصعود، الذي أكابده. لذاك الإنسان الذي بنى أوابده من حصون ومعابد وقلاع بحجارة ضخمة، ضخمة. كأنه تحالف منذ فجر الزمن مع الجبال لبنائها، بل في أعالي ذراها!.
كم كان هذا الإنسان رائعاً، فعالاً. هَمَزَ بحصان إرادته بريته المشتهاة وجمز!.
كان البناء، بحد ذاته، قديماً جداً، تكلّست عليه خرائب الدهور، وذكريات التاريخ السحيقة. يبدو أنه البناء الأول، في هذه البقعة الشاهقة من العالم. ظهر لي في بادئ الأمر، كبرج أثري. ثمَّ كبر هيكله واتسع، عن قرب، مثل قلعة، تحيط بها فلل متفاوتة الحجم، لتحميها. وتبقيها كصحن منيع.
وصلت، بعد جهد جهيد، ووقفت ألهث. ثمَّ عبرت السور. وتأكدت أن البناء مزيج من معبد وحصن معاً، كما يبنى الهرم. إذن هذا الهرم شيّد فوق هرم آخر، هو الجبل!.
وتقديراً آخر، للإنسان الأول، على بنائه هذا الهرم. وكيف جلب حجارته الضخمة من أمكنة بعيدة. وأشاد بها بناء على مرتفع سامق من كتلة الجبل. حقيقة هذا الأمر بالذات، ما زال محيّراً ويستوجب ((فكرة التجاوز))، في تفسيره. قالوا:
نقلت حجارته بقوة النظر... وكأن نبؤة نقل الأشياء المادية بقوة الذهن، أو الفكر تحققت في العهود القديمة قبل العهود الحديثة. المهم قبضت على وميض حلمي الهارب. وهاأنذا أقضي وقتاً داخل المكان الذي اختاره الرجل ـ موضوع مقابلتي ـ لإقامته، وكأنني داخل الأزل مكان رصّع بآثار العصور العابرة. دون جعجعة تاريخ، أو صهيل إعلام.
قال: كان معبداً أولاً ثمَّ تحوّل إلى حصن، مع مرور الزمن. ثمَّ إلى معبد.
ذهلت. فاجأني فيما كنت أخمّنه، كشخص مروّع بالنور يقرأ ما يضمر، قبل أن تولد الكلمة على الشفتين!.
يا للشفافية، كل الأحاسيس والخواطر! التي سأخلقها في داخلي، سيعلم بها.
أوغلت عيني محملقاً. بل بحثت في زوايا وجهه، عن بقايا علم خفي، وسر مؤجل. هل وصل إلى درجة الشخص ((العارف)) في شفافيته، ياتر...؟.
قاطعني فيما كنت أتمتمه في نفسي: صار ذاك الشخص يتلقى معرفته مباشرة. بعد أن جلس مدة عشرين عاماً تحت سلم بيته، لا يبرحه إلا لقضاء حاجة جسيمة.../ وصمت.
ـ إذن، وصل إلى مرتبة العابد الحقيقي؟.
هزّ رأسه، ونطق: آه...! ليتني أحظى بلحظة أنس مثله. فلحظة أنس تبرر عمراً كاملاً من الانتظار. لا عشرين سنة فحسب!.
ثمَّ عاد إلى ما كنا بصدده: ((الفجر القدسي انبثق مع الخليقة، مع البشرية الأولى.
فالعبادة كانت عندهم قبل القتال. والمعبد قبل القلعة ـ الحصن. والسلم قبل الحرب...))
أأبقى مصعوقاً؟.
حركت لساني سليقة: ((وفي عصرنا))؟
ابتسم. بل ضحك حتّى بانت نواجذه: وبعد أن شدَّ على يديه كأنه يستعيد شيئاً فقده. قال: (عصرنا هذا، ليس كما كان عصرهم، أو عصورهم...) وسكت.
وسكت مبتهجاً بسعادتي في مشاركته الكلام.
ثمَّ زفر بحرارة. وتابع يؤكد مقولاته: في ((البدء)): كانت الروح عندهم قبل الجسم. والـ((نحن)) قبل الـ((أنا)). والعقل قبل المادة. والله قبل الكون...)).
وأخذ يوضّح لي كيف حدث هذا التسلسل القدري، في دورة الكائنات، من قبل الخالق العظيم، المطلق. ((وهو فوق الكل. وقبل الكل))... وعلّل بسياق هذا القانون الكوني. كيف أن الإنسان نفسه تراه مدفوعاً طواعية، إلى قدره الثابت. لأنَّ ((قدره قد أُحدث منذ الأزل، لـهذا يجب أن لا يخاف من الموت. بل يخاف من (ما بعد الموت)...)).
ماذا أسمع؟ ماذا أسمع؟ أريد أن أنطق. جفّ لساني، وكأنه تحوّل (في حلقي) إلى قطعة من خشب...
ويسترسل ثانية: ((وبعد تسلسل عملية الخلق، التي وصلت بصفوتها إلى الإنسان.
((حلّت المقامات السامية))، و((الحجاب المكرم)).
تقديراً لـهذا الإنسان، وأنساً لـه، حتّى لا يستوحش في هذا الخلاء الكوني، بعقله الفعّال الذي منحه إياه ((باريه)) من كرم لدنه المقدس، ويظن أنه وحده في هذا الوجود الرحيب الرهيب. فعقله الفعّال هذا مادة إلهية بحت...)).
من خلال وعيي الهلامي. وجدت الرجل واقفاً أمامي يمد يده اليمنى ويصافحني.
بلى عدت وصحوت ممَّا كان قد أهبظ عقلي به من شروحاته ومقولاته. عفواً طالما حظيت بشرف مقابلته هذه وجب علي أن أحيطكم علماً بأحواله:
رجل نسيج وحده، من بين بني آدم. لـه أفكار وسلوك يخوّلانه أن يمتلك العالم بالوكالة. ولكن يقابل هذه القوة المعنوية عنده جسم رقيق نحيل. ذو بشرة ناصعة شفافة. تكاد ترى من خلالها العظام.
الرأس: مستدير، زادته هيبة ووقاراً عمامة بيضاء.
الوجه: على الرغم ممَّا لوّحه به الشيب والشمس والضنك (الزهدي)، الذي يعيشه، في هذه العزلة القاسية. كان بضاً منوّراً. نبت في الذهن واللهاذم، شعر خفيف مخلوط. تكاثر، نوعاً ما، تحت الأنف، وشكَّل ما يعرف بالشارب.
اللباس: رداء قماشي خشن. لونه أزرق. انسدل على جسده كقباء تغمره عباءة فضفاضة حيكت من الصوف. تماماً كما رأيته حين دعاني وأنا في تلك الأقاصي.
***
بعد أن عدت وعادت إلي أخباره. وتجشمت الصعود إليه. وجدته قد اختلف كثيراً عمّا كنت قد تركته في أيام الدراسة. طبعاً مرّ في مراحل الطفولة والشباب والكهولة. والآن هذا الشيخ لا أنكر أنه كان آن ذاك كل طفولتي وكان شبابي وكهولتي القادمين وأيضاَ ذكرياتي، ذكرياتي هذه التي أراني أرمِّم بها داخلي وأصلّح كيان نفسي. عهدته تلميذاً. وأراه قبالتي زاهداً ناسكاً وفقيهاً صاعداً.
نظر ثمَّ ذهب بعيداً في تفكيره إلى حيث لا أدري. وأنا بدوري، تركته وذهبت إلى الأسهل في رفقته ـ طفولته ـ.
حقيقة منذ أيام الدراسة الأولى، كانت لـه طفرات مشفوعة بسهوم وشرود شديدين. أفكار كالإلهام تراوده. كلام فوق المستوى المألوف ينطق به. كأنه كان يعد نفسه، ليكون أكثر من رجل في العالم!.
كنّا دوماً، ونحن في غرفة الصف الذي ننتسب، ننظر إلى شفتيه، وهما تتمتمان شيئاً لا يفهم. ثمَّ علمنا فيما بعد أنها صلوات وأدعية إلى الله، وكلام آخر: الخوف، القلق، المجهول، البقاء، الفناء، المصير، الكون...
طفل تشنقه مفردات لغة كامنة حبيسة في باطنه تريد أن تخرج. ويبرر السؤال: هل هذه الطلسمات آتية إليه من كوكب آخر؟ أم من أطلس موطن الذكريات الأولى؟
ثمَّ نراه تنساب تعاريج الدموع على خديه. وتغطي وجهه بالكامل، دونما سبب. أحياناً كنا نظن أنه يهذي. كلام غير معقول بالنسبة لنا، هذا الذي نسمعه يتردد على لسان زميلنا (سعيد). حتّى معلّم الصف احتاط لـه المسكين. أخذ يكلف نفسه جهداً إضافياً، في العودة إلى المراجع والمصادر احتساباً لـهذا الطالب ذي الأطوار الغريبة، الذي ينفجر زلزال أسئلته كل يوم، وإلا تراه سيبخس أمام الطلاب، شر بخسةٍ ويغتسل وجهه بقطرات العرق!.
بطبيعة الحال، ملازمتي لـه في رفقته المدرسية، لشد ما تأثرت بها، وأخذت تنعكس على سلوكي. بل كان لـها الدور الأساسي، في تكوين جانب هام من شخصيتي. ومنها الدافع الرئيس لوجودي هنا، في هذا المعبد، ألاحقه كالتابع.
تأكيداً في أيام التلمذة كنت أعجز عن مجاراة ذاك الصوفي الصغير في السمات والسلوك اللذين دأبهما. وإن امتثلت لبعض إرشاداته وعظاته، حسب استطاعتي. غير أن هذا الزميل الصديق كان معي بالمقابل ـ متسامحاً ديموقراطياً ـ يترك الأمور لي كاختبار. هو منذ الصغر يقدّر حرية الفرد الشخصية.
ـ ((المهم أن تكون رجلك على الطريق وما كلّف الله نفساً إلا وسعها)).
وعلى الرغم من قاعدته التي يتلوها يحضّنا إلى تطلعاته التي ينشدها خارج الحياة على سطح هذه الأرض ـ على حد تعبيره ـ يريد أن نحلّق معه بأجنحة يمام خارج ((سجن الأرض)). ثمَّ صار يستعمل مصطلح ((النقلة)).
من أين آتى به؟.
من علّمه إياه؟.
من خلفه في هذه الثقافة العلوية؟.
كأن هذا الطالب الصغير كان يحوي كنوز المعرفة اليقينية أو المعرفة الإيمانية بالله. من جهتنا كنّا في جهل مطبق، في شؤونه الخاصة. وفي بيته وفي نومه وفي مأكله ومشربه. يكرّر علينا مصطلحه (النقلة) في كل حديث يدلي به عن مصير الإنسان، إذ تبقى مثل كائن أخضر مستقراً في أعماقه. ويحثّنا لقبولها كمسلمة. ((ينتهي المنطق عندما يبدأ الإيمان))...
لم نكن نعي ما يقوله. ولا ما يشرحه عن المدن النجمية، التي تنتظر الإنسان في حياته الثانية. مدن تقع في البعد السحيق من زاوية الكون القصوى. لـها مدارات وأفلاك تدور حول شموس وكواكب أخرى. ((الأصح في مفهوم الخلود الإنساني، هو تغيّر الأقمصة بالجسد، بعد الهبوط. فالروح واحدة وباقية. وفي الخلاص تصعد بهويتها وتنعم بحريتها الأبدية...)).
وكم أجدني ارتجف خوفاً وهلعاً. ويتخبّط جسمي بقشعريرة مرعبة وهو يتحدّث لي عن الموت ونقل الروح، وفناء الجسم... وأنا الرعديد المشدود بتوتره كطفل. وهو بجانبي، كالرجل الناضج الذي يخوض في أحاديث الثواب والعقاب والبقاء والفراق. دون أن تهتز في بدنه شعرة.
***
تعال.
قادني، أدور معه في المكان.
لم أستسلم في يومٍ من الأيام لـهلع مثلما استسلمت لـه اليوم. يا ألله! رأيت الأرض في الـ((تحت)) البعيد مدحوة سهولاً ووهاداً. كأنني أقف على جرف هاو.
طبعاً، طرأت تحسينات إضافية على المبنى القديم. ومع هذا كان فعل الزمن بادياً في تفتيت حجارته العملاقة، بما كسيت به من دمن الطحالب. والأشنيات.
ـ ((هذه النباتات القميئة كفيلة بفناء كل هذه الصخور الجبارة. هي مثل الطواحين تفرم وتسحق بماكينات رحاها التي لا تُرى بالعين المجردة، كل الأشياء التي تعلق بها، وتجعلها كالدقيق...)) /سكت/.
ثمَّ عاد بعد قليل إلى النغمة الأولى يعزف على وتر الفناء: ((سائر الموجدات في هذا الكون آيلة إلى التلاشي والاضمحلال. الإنسان يدخل إلى هذه الدنيا عارياً ويخرج منها باكياً...)) صمت.
ظللت ساكتاً معه بلساني وأتكلّم في نفسي: أكدت مرّة أخرى أنني أتلقى اليوم درساً بليغاً في علم الفناء!.
ـ ((ما أقوله هو الصح)). أردف.
ثمَّ ذكر أنه قرأ في ((علم المادة)) أو ما يسمى بالجدل المادي أن الفناء لا يصيب سوى العالم الظاهر. عالم الأجسام ـ المادي ـ وأوضح أن التجارب المخبرية دلّت على أن المادة في هذا الكون، ما هي إلا طاقة مكثّفة. وأهم هذه التجارب: غرفة العالم (نيلسون). ((العالم كان أولاً روحاً، عقلاً، طاقة. ثمَّ تكثف قسم منه وتحوّل إلى مادة... فالفرع يلحق الأصل. والتابع يتبع المتبوع)). من جهتي لا أقول في هذه القضية إنه وظّف هذه المصادرة لمصلحة مبدئه الروحي، بل أيقنت أن ما يقوله هو الأصل.
((النفس مع المصدر، فهي لا تفنى. هي خالدة... يعني عالم الروح هو الباقي)).
لَهَجَ نفساً كثيفاً، تابع: ((البحر يتبخّر ماؤه. ولا تبقى إلا حركته (الأزلية ـ الأبدية)...)).
أجبت بعفوية: إذن الحركة هي الروح.
انبسطت أساريره. ثمَّ أخذ يشرح لي، كيف يموت البحر. ولا تبقى منه إلا الحركة ـ الروح. ليدل على أن الحركة هي تحرر وحرية، تتم بفضل الموت. أي الانعتاق من المادة ـ الجسم ـ لتعود بجوهرها الحر كيقظة أبدية، ووعي شامل للوجود الحق. ((الإنسان الذي يعيش اللاحقيقة في الأشياء، عن طريق عالم المادة والأجسام الظاهرة كان يعيشها في البداية معنى وحرية وحقيقة...)).
ثمَّ: ((ولكن عندما حلت الروح في الجسم، وهبطت. كبلت حرية الإنسان... لـهذا ترى الإنسان نفسه، يحن إلى العودة إلى حريته الأولى بوساطة الموت)).
واستشهد بسقراط الذي تقبل زعاف الموت بحرية تامة لينعتق من كبل الجسد، من أجل أن يعود إلى حريته.
ولا أعلم كيف عدت ونطقت هذه الكلمة بصيغة الاستفهام: والحرية؟
أخذ يشرح:
ـ ((الحرية بجوهرها، هي النعيم المفعم بالسعادة الحقيقية. و...)). وتركته يتكلم وحده، وهو يهدج أمامي، بعد أن قطع أنفاسي إدهاشاً، بقوة أفكاره، وعمق ثقافته، واتساع معرفته وإطلاعه! ما هذا النوع الممتاز من الناس؟ هم كأنهم يرون ما لا تراه العيون والحواس.
جماعة نخبة مشدودة إلى عوالم أخرى. وحقائق أخرى!.
رفقتي لـه، بالنسبة لي، ستكون صعبة وشاقة.
وأراني قد خامرني خاطر: شيخ سعيد كيف استطعت أن...
ـ ((قل سعيد. لقب شيخ لا أستحقه)).
واه...)! واستدارت عيناي. إلى هذه الدرجة التواضع والزهد في الذات. إنه شيخ ونصف. بل يساوي ألف شيخ من...
ـ لا تكمل.
يا للفضيحة! وظللت متلبساً ما بين الحقيقة والخيال. عجيب يعرف كل ما أنوي أن أقوله!.
ـ ((الضرب بالألقاب. الزهد بـ((الأنا)). هما السبيل إلى الله. قرأت لأحد المعلمين: لا يجد ناسك حلاوة الحياة الأخرى، وهو يحب أن يعرفه الناس...)).
وسكت هنيهة. ثمَّ افترت شفتاه:
ـ ((لكل معلم نداء.... في البدء كان النداء للإنسان)).
أخذتني عدوى النداء. فانزلق عن لساني: وما هو نداؤك، يا شيخ...؟
ـ إياك تلفظها. بل سعيد وحسب!
ابتسمت.
ثمَّ أجابني: ((دعك من ندائي وهاك نداء معلم آخر. باركه الله وأودع فيه سرّاً من حكمته، كإنسان صالح ورع، كان في صحراء. عثر على قبرة عمياء. يسّر الله رزقها بوساطة دابة أخرى. فهتف في داخل نفسه: يا ارحم الراحمين ارحمني...
ورحمه الله. إذ غرس في أعماق قلبه محبته، وانقطع إليه عبادةً وسلكاً)).
بعد ذلك تابع يمشي، يشير إلى معالم المعبد، ويعيد عليّ شيئاً من تاريخه.
***
عندما جلسنا للاستراحة، عادت نواقيس ((الأنا)) تدق في خاطره كشغل شاغل لـه. آهة لاهبة خرجت من قاع جوفه، وفهمت ممَّا شرحه بلغته: أن ((الأنا)) الجزئية ـ الفردية هي شرٌّ بحت. لذا يجب ألا تبقى إلا ((الأنا)) الجمعية. أنا واحدة، كلية. تمحى فيها كل الأنوات الجزئية، في هذا الوجود.
وأخذ يحلل بموجب منطقه:
ـ ((فالجزء هو جزء من الكل. كما أن الخاص هو جزء من العام. وبموجب هذا ((القياس)) الأرسطي ـ هكذا لفظ ـ تكون الحقيقة المطلقة الكلية هي الشاملة، لكل العناصر الجزئية في الوجود...)).
سكت قليلاً ثم أردف" طبعاً الجزء أو العنصر الفرد، لا يكتمل معناه وجوهر وجوده إلا بالكل نفسه. مثل مفردات دقائق الذرة نفسها. فهذه لا تشكل ذرة كاملة إلا إذا اندمجت دقائقها في منظومة واحدة...).
كذلك تابع بعد أن شهق نفساً: ((فالكون منظومة مكبرة بأجرامه كما هو منظومة مصغرة بذراته...)).
تهت في شروحاته الطلسمية هذه ولا أدري كيف تلجلج لساني: ((وما يعني الإنسان))؟
ـ ((الجانب الإنساني واضح كالشمس. فالمرء إذا ما تعصب إلى أناه وأراد أن يستقل بذاته. فليس بمستطاعه ذلك. ويخالف الناموس الكوني)).
ثمَّ راح يربط كل هذه الأمور برباط لاهوتي محض: ((تعليل كل ما سقته هو أن الإنسان مخلوق من خالق يمتلك البداية والنهاية في هذا العالم الذي أبدعه بقدرته الكاملة. إذ ليس بمقدور المخلوق المحدود. في نهاية مطافه، إلا أن يعود، ويذوب في اتحاده بالخالق المطلق، اللامحدود...).
وسكت ينفث أنفاسه الحارّة كالمعتاد.
كنت بجانبه كالثمل وما عليّ إلا أن أنطق: ((زدني علماً يا رعاك الله))!.
أثبت نظره عليّ: ((وهنا يبلغ الإنسان أعلى مراتب التأييد والقوة والعرفان...)).
ثمَّ أخذ يقص عليّ قصة فرعون الذي طغى: فاستغل بـ((أناه)) فآل إلى بئس المصير.
وكذلك قصة النمرود المعروفة. فبعد أن استعلى واستكبر بتضخيم أناه أرسلت إليه بعوضة صغيرة (برغشة) دخلت أنفه وراحت تأكل فيه. وكان لا يهدأ رأسه من الصراع إلا إذا ضرب بحذائه. من قبل خادمه...
وأيضاً جدائل (سالومي) تماوجت على كتفها أمام (الاسخريوطي) ليقطع لـها رأس (يوحنا)، انتقاماً لـ((أناها)) وغرورها بجمالها، التي استصغرت عنده كل جمال فاتنات الدنيا و((مصيرها معروف)).
وختم شواهده بـ((قبل كل ذلك إبليس كان أول من تكبّر وكفر باستقلال ((أناه))، عن خالقه حيث استقرت فيه بداوته الضديّة...)).
ثمَّ أشرق وجهه بابتسامة. كأنه راض عن هذه ((التزكيات)) الانتقائية، التي أوردها، لتثبيت مقولته بضعف ((الجزئية)) وانتصار ((الكلية)).
من جهتي كنت قلقاً ومبعثراً. تأخذني هواجس العجز والتقصير. أو على الأقل استيعاب الكلام. أجل لا طاقة لي على ذلك. كيف صار هذا الرجل في هذا المستوى العالي من الفكر والفلسفة والتجهّد؟ هل الانقطاع إلى الله فكر بحد ذاته؟ أم هل العبادة أضحت بجوهرها عنده فلسفةً؟ وفلسفة نوعية!.
ثمَّ مطاردة أخرى:
((الأقمطة، والألبسة لا تستر الروح. بل تبلى مع الجسد بالتراب...)) نَدَّ من ناحيتي جواب تقليدي ـ حسب مكنتي:
ـ ((هذه حال الدنيا، يا... سعيد))/. ورجفت عندما لفظت اسمه منفرداً.
وبعد لحظة صمت. جاملني في تقليديتي ليعيد إليّ شيئاً من الاعتبار:
ـ ((لاشك أن الحياة الأولى صعبة على الإنسان، إذا ما اتخذها بجدية تامة. فهي لـه كمن يمشي تحت حر الهاجرة. أو كمن يُصاب بظمأ في رمضاء قائظة. أي هذه الحياة رحلة امتحان، على رفيف وعود الجنة وترانيم الوصايا العشر)).
نطقت: ((من هنا وجب السباق في دار الفناء، من أجل السعادة في دار البقاء)).
أجاب: ((طبعاً، هذه حكمة ثنائية العالم. تكشف نفسك بضدك وتعرف فضيلة الخير من رذيلة الشر))...
ثمَّ أطرق. وساد صمت طويل بيننا ونحن نمشي، حتّى انقلب الوقت جثةً هامدة. أيضاً لـه فلسفته في الإطراق والصمت!.
انفرجت أسارير وجهي بعض الشيء وأنا راجع إلى المعبد. لما جلست معه على الشرفة المطلّة. عدت ونظرت إلى أسفل. كنت كمن ينظر عن رأس مثلث لمجسم عالٍ عظيم. أُراني أُعذر إذا ما حبست نفسي في كبسولة فضائية، يا لـهذه الجبال التي انطوت على أسرارها، وأخذت تتأمل صغار الكائنات تحتها!
حركت شفتي وأنا ألتقط لـهاثي: ((الذروة ذورة في كل شيء، أنت في هذا العلو تعيش قريباً من القمر، قريباً من الشمس قريباً من النجوم)).
ـ قل قريباً من الله، فأنت ما زال تفكيرك تحت دائرة اللون الأزرق. تعيش حالة التجسيم فقط. يلزمك مران...)). وران علينا صمت آخر بجلال مهيب.
ثمَّ رجف فمي ((جئتك صاعداً، كمن يتسلق شجرة باسقة لأكتسب)).
أجابني: ظاهرية الأشياء هذه، هي مقتلك. فأنت تعني صعود الجبل لا صعود النفس.
نكَّست رأسي.
خفف هو من خجلي، بإشارة لطيفة من يده، إلى حيث المكان الذي يسكن داخل المعبد، ويجري فيه طقوسه.
شاهدت كهفاً في الركن الشرقي من المعبد، يوجد فيه أثاث بسيط: بطانية، فراش، بساط عتيق.
تمتمت في داخلي: هنا يعيش هذا الناسك بقلبه الأبيض. ومن هنا ينطلق به نحو حنين فضاء أزرق.
بعد لأي فطنت: ((والأكل))؟
ـ ((ألم أقل لك إنني قريب من الله...))/ لم يكمل.
ولكن بعد قليل أردف: ((انظر إلى تلك البقولات المخضرة والأشجار المثمرة التي تحيط" الجوز، واللوز البري. ولا تنس العنب. والبطم مفيد جداً بزيته للجسم، والتين والزيتون...)).
أكملت مباشرة: وطور سنين.
ابتسم الأكل الحلال بالنبات. والإنسان نباتي بالفطرة كالحيوان. الجسم واحد في كلا المخلوقين. ولكن عندما تجرأ الأول على مملكة الثاني. عاد وتجرأ على مملكته هو أيضاً وعاث فيها قتيلاً وفتكاً.
ثمَّ أخذ يشرح لي نظرية فيلسوف نباتي معاصر. حلّل فيها طبيعة الإنسان إلى صنفين: صنف دموي نزاع بميوله النفسية إلى الشر والعدوان. بسبب أنه حيواني ـ أي من أكلة لحم الحيوان ـ وصنف رحماني، يهدف بسلامه النفسي للخير والسلام لأنَّه نباتي ـ أي من أكلة النبات ـ... وبعد أن سكت اعتلت وجهه غيمة غضب، ولا أدري كيف تداعى لذهني مباشرة تقسيم العالم إلى غرب وشرق.
فنطق: ((صح. صح الغربي حيواني. والشرقي نباتي)).
وأوضح ما كنت فكرت فيه. ثمَّ هدر: الفجر الأقدس كان قبل الطوفان. كان الإنسان خيّراً نقيّاً.
ثمَّ تحركت فيه نوازع الأنا فاعتدى على غيره، وعلى جنسه. فحلّت المأساة وجاء الطوفان. وعاد الخلق وللآن لم يرعو.
أخذ نفساً، وتابع بغيظ ((أودَع الإنسان الغربي في ذاكرة التاريخ الحديث حربين عالميتين مدمّرتين. لا يفصل بينهما سوى عشرين سنة، وسفك فيهما ملايين ملايين القتلى على ظهر هذه الأرض العجوز)).
وصمت. وسكن المكان.
عجيب كيف لـه هذه القدرة الخارقة على خلق الصمت. وأنا صرت بدوري مأخوذ به عاد ونظر إلي مشفقاً.
نطقتُ بتشجيعه: ((قيام حروب (الغرب) هذه وأنهار الدماء التي دعجت تمّت بفعل قانون (أكل اللحم)!...)).
طامن برأسه: نعم/ بل شدّد بنطق هذه الكلمة.
جال في خاطري عندما كنت أجوب الأرض الرعوية، الواقعية في التخوم الجنوبية، بحثاً عن الكمأة، بعد أن تركته وتركت المدرسة، وشاهدت بركة ماء تآخت حولها الطيور والحيوانات. تأكل وتشرب بسلام، إلا ذاك الذئب المفترس.
ندّ من جهته، صوت:
((المفترس هو المفترس. هو الذي يفترس مخلوقاً آخر، سواء أكان إنساناً أم ذئباً ضارياً؟)).
هنا فطنت: ((ظهرت جماعة من الزهاد في الغرب، فرزتهم حضارته وعاشوا على هامشها)).
لاح طيف ابتسامة نائسة على شفتيه. ثمَّ انفرجتا: ((تعني الهيبيين)). هؤلاء متصوفون أرضيون، ماديون ووجوديون. لا يعرفون التصوّف الحقيقي، ولا بما تعنيه الزهادة الروحية من تقوى وفضيلة وصلاح. بل يستعملون ما يدّخرونه من احتياطي جنونهم، في إبطال مفعول العقل السليم. ويدفعهم هذا الأمر، بالتالي إلى سلوك عابث، في حياة ماجنة مقرفة... أهذا زهد...))؟.
ثمَّ استدرك: وأما أولئك المستغربون الذين ينتحرون بالسيف (السامورائي) وبطريقة (الهاراكيري) يرتمي الواحد تلو الآخر. فأي زهد في هذا الجبن؟ في هذا الهروب؟
ـ ((............))/ فترة سكوت وراحة سادت بيننا.
ثمَّ لا أدري كيف كسرت رهبة هذا الصمت. وتلجلج لساني باستحياء: ((أنت رجل (شرقي) صيني)).
حدّق إليّ: ((ليتني أكون من أهل تلك الصين)).
وكاد يشرق بدمعة. بيد أنه عاد وفطن: ((الصين الجوّانية لا الصين البرّانية)). صين هذا الزمان. بدوري رحت أحتمي بسكوتي المفضل، وأنا أفتكر. بل كأنني أصبت بدوران الذاكرة. فعدت إلى سني حياتي الأولى، فحين كنت طفلاً، كانت المرحومة جدتي (هدية) تحدّثني عن سكان تلك الصين، الصين الجوانيّة وفضائلهم وأخلاقهم: هم من أهل الخير. كلّهم أناس طيبون، أخيار، أتقياء. وكل من يصفو في عالمنا البراني هذا ينتقل إليها، بعد الموت)).
كم كان يشوقني حديث جدتي هدية عن هذه الصين الخيّرة فاستقبله بحواسٍ متوهّجة، حتّى صرت أتمنى أن أترك، باكراً حياتي المعطوبة هنا وأنتقل إلى حيث يعيش ((أهل الخير)) المشمولين بالرعاية والكلاية من لدن العناية الإلهية. أعيش معهم. وأسوّي مثلهم مساكن الريحان والزعفران، وأعيش هناك حيث اللازمان واللامكان. أندمج في روح الكون الأبدي دون نهاية. وهكذا لم أعد أخشى ممَّا وراء الموت. بل أضحى الموت عندي انتظاراً. وكأني معه، على موعد ساحر.
قاطعني: ((صح الموت بحقيقته انتظار عودة)).
سكت سبحان الله! استشفّ ما تمتمته في داخل نفسي.
***
حين عدلت عن مغادرة المعبد. فطنت. وقلت: ((أيوجد هنا ماء يا... سعيد)).
وابتسمت لترديد اسمه منفرداً.
نهض: ((تعال)).
قادني من يدي إلى مغارة، خارج سور المعبد. شاهدت في وسط المغارة حوضاً مملوءاً بالماء. السقف يرشح بنقاط متتابعة، متلاحقة، بانتظام تصلح لتكون ساعة مائية.
ـ ((هذه مغارة النقاطة) ولها قصص عجيبة، مع عابد سابق. ومن الصعب المستصعب أن تصدق. إلا عند ذوي ((التجاوز))، والكرامات. خلاصتها: حدث انبجاس نقاط الماء من السقف، كرامة لذلك العابد. بعد أن انقطع هنا للعبادة.
ثمَّ كفّ عن الكلام. ألححت عليه أن يسرد لي قصة ذلك الناسك الفاضل بالتفصيل، أبى لقناعته أنني ما زلت من أهل الشك لا من أهل التجاوز، على حد تعبيره بالذات...
ـ ((أنت ما فتئت تقع تحت خط اللون الأزرق. أي لا تؤمن بالانفكاك من قوانين كينونة المادة ولا بحضارة اللدن)).
فدفعت بفضولي المعروف، لأتعرّف إلى ذاك الأمر الذي يعنيه ويرمي إليه.
ـ ((سبحان الله! هل رأيت كائناً يخرج من قيود (المادة الفيزيائية): المكان والزمان؟ أنا آمنت ورأيت هذا الكائن العلوي...؟)).
وبعد أن سكت قليلاً، استأنف: ((الخلاصة في هذا الصدد أن هذا الكون الأرحب باتساعه ووجوده المطلقين، لا يحدّ بثلاثة أبعاد أو أربعة: (طول، عرض، ارتفاع، وسرعة الضوء ـ النسبية). بل لـه أكثر من عشرين بعداً والحبل على الجرار)).
وهنف بضحك خفيف. ثمَّ تابع: ماذا نقول في كوكب انفلت من مساره وحطّم ناموس المدارات؟... والإنسان بحد ذاته كوكب يحلّق فوق الأرض نحو الزرقة بعد أن يصبح عارفاً بالله. والعلم لديه حضور دائم، دون حزن ماضٍ ولا خوف مستقبل... نعيم... نعيم...!.
تكلّمت وأنا مطبق شفتي: قرأت في قصة إبراهيم أن النار المحرقة أضحت برداً وسلاماً على عارف بالله، منذ آلاف السنين. أوعل عينيه بي.
ـ أف...! أراني قد تصدع رأسي. إن ما كان قد سكبه هذا العابد في ذهني. في هذه الجلسة الشاقة شيء يفلق الجبل لا الرأس! هأنذا قد مللت وكأنني صرت أجلس بين يديه دون نيّة. عسر فهم اعتراني. ودارت بي الأخيلة. بل أنا الذي درت بها. حتّى غيَّبتها. أو غيَّبتني في غياهب عوالمها.